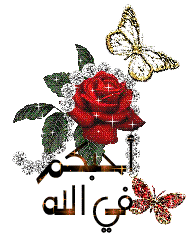العلمانيون هم: كل من ينسب أو ينتسب للمذهب العلماني، وينتمي إلى العلمانية فكراً أو ممارسة.
وأصل العلمانية ترجمة للكلمة الإنجليزية (secularism) وهي من العلم فتكون بكسر العين، أو من العالَم فتكون بفتح العين وهي ترجمة غير أمينة ولا دقيقة ولا صحيحة، لأن الترجمة الحقيقية للكلمة الإنجليزية هي (لا دينية أولا غيبية أو الدنيوية أولا مقدس).
نشأت العلمانية في الغرب نشأة طبيعية نتيجة لظروف ومعطيات تاريخية –دينية واجتماعية وسياسية وعلمانية واقتصادية- خلال قرون من التدريج والنمو، والتجريب، حتى وصلت لصورتها التي هي عليها اليوم..
ثم وفدت العلمانية إلى الشرق في ظلال الحرب العسكرية، وعبر فوهات مدافع البوارج البحرية، ولئن كانت العلمانية في الغرب نتائج ظروف ومعطيات محلية متدرجة عبر أزمنة متطاولة، فقد ظهرت في الشرق وافداً أجنبياً في الرؤى والإيديولوجيات والبرامج، يطبق تحت تهديد السلاح وبالقسر والإكراه؛ لأن الظروف التي نشأت فيها العلمانية وتكامل مفهومها عبر السنين تختلف اختلافاً جذرياً عن ظروف البلدان التي جلبت إليها جاهزة متكاملة في الجوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتاريخية والحضارية، فالشرط الحضاري الاجتماعي التاريخي الذي أدى إلى نجاح العلمانية في الغرب مفقود في البلاد الإسلامية، بل فيها النقيض الكامل للعلمانية، ولذلك كانت النتائج مختلفة تماماً، وحين نشأت الدولة العربية الحديثة كانت عالة على الغربيين الذين كانوا حاضرين خلال الهيمنة الغربية في المنطقة، ومن خلال المستشارين الغربيين أو من درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية، فكانت العلمانية في أحسن الأحوال أحد المكونات الرئيسية للإدارة في مرحلة تأسيسها، وهكذا بذرت بذور العلمانية على المستوى الرسمي قبل جلاء جيوش الاستعمار عن البلاد الإسلامية التي ابتليت بها.
ومن خلال البعثات التي ذهب من الشرق إلى الغرب عاد الكثير منها بالعلمانية لا بالعلم، ذهبوا لدراسة الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك والرياضيات فعادوا بالأدب واللغات والاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية والنفسية، بل وبدراسة الأديان وبالذات الدين الإسلامي في الجامعات الغربية، ولك أن تتصور حال شاب مراهق ذهب يحمل الشهادة الثانوية ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه، بعد أن يكون قد سقط أو أسقط في حمأة الإباحية والتحلل الأخلاقي وما أوجد كل ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب فكري، ليعود بعد عقد من السنين بأعلى الألقاب الأكاديمية، وفي أهم المراكز العلمانية بل والقيادية في وسط أمة أصبح ينظر إليها بازدراء، وإلى تاريخها بريبة واحتقار، وإلى قيمها ومعتقداتها وأخلاقها –في أحسن الأحوال- بشفقة ورثاء، إنه لن يكون بالضرورة إلا وكيلاً تجارياً لمن علموه وثقفوه ومدّنوه، وهو لا يملك غير ذلك.
ثم أصبحت الحواضر العربية الكبرى مثل: (القاهرة-بغداد-دمشق) بعد ذلك من مراكز التصدير العلماني للبلاد العربية الأخرى، من خلال جامعاتها وتنظيماتها وأحزابها، وبالذات دول الجزيرة العربية، وقل من يسلم من تلك اللوثات الفكرية العلمانية، حتى أصبح في داخل الأمة طابور خامس، وجهته غير وجهتها، وقبلته غير قبلتها، إنهم لأكبر مشكلة تواجة الأمة لفترة من الزمن ليست بالقليلة.
ثم كان للبعثات التبشيرية دورها، فالمنظمات التبشيرية النصرانية التي جابت العالم الإسلامي شرقاً وغرباً من شتى الفرق والمذاهب النصرانية، جعلت هدفها الأول زعزعة ثقة المسلمين في دينهم، وإخراجهم منه، وتشكيكهم فيه.
ثم كان للمدارس والجامعات الأجنبية المقامة في البلاد الإسلامية دورها في نشر وترسيخ العلمانية.
ثم كان الدور الأكبر للجمعيات والمنظمات والأحزاب العلمانية التي انتشرت في الأقطار العربية والإسلامية، ما بين يسارية وليبرالية، وقومية وأممية، سياسية واجتماعية وثقافية وأدبية بجميع الألوان والأطياف، وفي جميع البلدان حيث إن النخب الثقافية في غالب الأحيان كانوا إما من خريجي الجامعات الغربية أو الجامعات السائرة على النهج ذاته في الشرق، وبعد أن تكاثروا في المجتمع عمدوا إلى إنشاء الأحزاب القومية أو الشيوعية أو الليبرالية، وجميعها تتفق في الطرح العلماني، وكذلك أقاموا الجمعيات الأدبية والمنظمات الإقليمية أو المهنية، وقد تختلف هذه التجمعات في أي شيء إلا في تبني العلمانية، والسعي لعلمنة الأمة كل من زاوية اهتمامه، والجانب الذي يعمل من خلاله.
ولا يمكن إغفال دور البعثات الدبلوماسية: سواء كانت بعثات للدول الغربية في الشرق، أو للدول الشرقية في الغرب، فقد أصبحت في الأعم الأغلب جسوراً تمر خلالها علمانية الغرب الأقوى إلى الشرق الأضعف، ومن خلال المنح الدراسية وحلقات البحث العلمي والتواصل الاجتماعي والمناسبات والحفلات ومن خلال الضغوط الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي، وليس بسر أن بعض الدول الكبرى أكثر أهمية وسلطة من القصر الرئاسي أو مجلس الوزراء في تلك الدول الضعيفة التابعة.
ولا يخفى على كل لبيب دور وسائل الإعلام المختلفة، مسموعة أو مرئية أو مقروءة، لأن هذه الوسائل كانت من الناحية الشكلية من منتجات الحضارة الغربية –صحافة أو إذاعة أو تلفزة- فاستقبلها الشرق واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتها، وكان الرواد في تسويق هذه الرسائل وتشغيلها والاستفادة منها إما من النصارى أو من العلمانيين من أبناء المسلمين، فكان لها الدول الأكبر في الوصول لجميع طبقات الأمة، ونشر مبادئ وأفكار وقيم العلمانية، وبالذات من خلال الفن، وفي الجانب الاجتماعي بصورة أكبر.
ثم كان هناك التأليف والنشر في فنون شتى من العلوم وبالأخص في الفكر والأدب والذي استعمل أداة لنشر الفكر والممارسة العلمانية.
فقد جاءت العلمانية وافدة في كثير من الأحيان تحت شعارات المدارس الأدبية المختلفة، متدثرة بدعوى رداء التجديد والحداثة، معلنة الإقصاء والإلغاء والنبذ والإبعاد لكل قديم في الشكل والمضمون، وفي الأسلوب والمحتوى، ومثل ذلك في الدراسات الفكرية في علوم الاجتماع والنفس والعلوم الإنسانية المختلفة، حيث قدمت لنا نتائج كبار ملاحدة الغرب وعلمانييه على أنه الحق المطلق، بل العلم الأوحد ولا علم سواه في هذه الفنون، وتجاوز الأمر التأليف والنشر إلى الكثير من الكليات والجامعات والأقسام العلمية التي تنتسب لأمتنا اسماً، ولغيرها حقيقة.
ولا يستطيع أحد جحد دور الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين مستثمرة في الجانب الاقتصادي.
هكذا سرت العلمانية في كيان الأمة، ووصلت إلى جميع طبقاتها قبل أن يصلها الدواء والغذاء والتعليم في كثير من الأحيان، ولو كانت الأمة حين تلقت هذا المنهج العصري تعيش في مرحلة قوة وشموخ وأصالة لوظفت هذه الوسائل توظيفاً آخر يتفق مع رسالتها وقيمها وحضارتها وتاريخها وأصالتها.
وأصل العلمانية ترجمة للكلمة الإنجليزية (secularism) وهي من العلم فتكون بكسر العين، أو من العالَم فتكون بفتح العين وهي ترجمة غير أمينة ولا دقيقة ولا صحيحة، لأن الترجمة الحقيقية للكلمة الإنجليزية هي (لا دينية أولا غيبية أو الدنيوية أولا مقدس).
نشأت العلمانية في الغرب نشأة طبيعية نتيجة لظروف ومعطيات تاريخية –دينية واجتماعية وسياسية وعلمانية واقتصادية- خلال قرون من التدريج والنمو، والتجريب، حتى وصلت لصورتها التي هي عليها اليوم..
ثم وفدت العلمانية إلى الشرق في ظلال الحرب العسكرية، وعبر فوهات مدافع البوارج البحرية، ولئن كانت العلمانية في الغرب نتائج ظروف ومعطيات محلية متدرجة عبر أزمنة متطاولة، فقد ظهرت في الشرق وافداً أجنبياً في الرؤى والإيديولوجيات والبرامج، يطبق تحت تهديد السلاح وبالقسر والإكراه؛ لأن الظروف التي نشأت فيها العلمانية وتكامل مفهومها عبر السنين تختلف اختلافاً جذرياً عن ظروف البلدان التي جلبت إليها جاهزة متكاملة في الجوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتاريخية والحضارية، فالشرط الحضاري الاجتماعي التاريخي الذي أدى إلى نجاح العلمانية في الغرب مفقود في البلاد الإسلامية، بل فيها النقيض الكامل للعلمانية، ولذلك كانت النتائج مختلفة تماماً، وحين نشأت الدولة العربية الحديثة كانت عالة على الغربيين الذين كانوا حاضرين خلال الهيمنة الغربية في المنطقة، ومن خلال المستشارين الغربيين أو من درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية، فكانت العلمانية في أحسن الأحوال أحد المكونات الرئيسية للإدارة في مرحلة تأسيسها، وهكذا بذرت بذور العلمانية على المستوى الرسمي قبل جلاء جيوش الاستعمار عن البلاد الإسلامية التي ابتليت بها.
ومن خلال البعثات التي ذهب من الشرق إلى الغرب عاد الكثير منها بالعلمانية لا بالعلم، ذهبوا لدراسة الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك والرياضيات فعادوا بالأدب واللغات والاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية والنفسية، بل وبدراسة الأديان وبالذات الدين الإسلامي في الجامعات الغربية، ولك أن تتصور حال شاب مراهق ذهب يحمل الشهادة الثانوية ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه، بعد أن يكون قد سقط أو أسقط في حمأة الإباحية والتحلل الأخلاقي وما أوجد كل ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب فكري، ليعود بعد عقد من السنين بأعلى الألقاب الأكاديمية، وفي أهم المراكز العلمانية بل والقيادية في وسط أمة أصبح ينظر إليها بازدراء، وإلى تاريخها بريبة واحتقار، وإلى قيمها ومعتقداتها وأخلاقها –في أحسن الأحوال- بشفقة ورثاء، إنه لن يكون بالضرورة إلا وكيلاً تجارياً لمن علموه وثقفوه ومدّنوه، وهو لا يملك غير ذلك.
ثم أصبحت الحواضر العربية الكبرى مثل: (القاهرة-بغداد-دمشق) بعد ذلك من مراكز التصدير العلماني للبلاد العربية الأخرى، من خلال جامعاتها وتنظيماتها وأحزابها، وبالذات دول الجزيرة العربية، وقل من يسلم من تلك اللوثات الفكرية العلمانية، حتى أصبح في داخل الأمة طابور خامس، وجهته غير وجهتها، وقبلته غير قبلتها، إنهم لأكبر مشكلة تواجة الأمة لفترة من الزمن ليست بالقليلة.
ثم كان للبعثات التبشيرية دورها، فالمنظمات التبشيرية النصرانية التي جابت العالم الإسلامي شرقاً وغرباً من شتى الفرق والمذاهب النصرانية، جعلت هدفها الأول زعزعة ثقة المسلمين في دينهم، وإخراجهم منه، وتشكيكهم فيه.
ثم كان للمدارس والجامعات الأجنبية المقامة في البلاد الإسلامية دورها في نشر وترسيخ العلمانية.
ثم كان الدور الأكبر للجمعيات والمنظمات والأحزاب العلمانية التي انتشرت في الأقطار العربية والإسلامية، ما بين يسارية وليبرالية، وقومية وأممية، سياسية واجتماعية وثقافية وأدبية بجميع الألوان والأطياف، وفي جميع البلدان حيث إن النخب الثقافية في غالب الأحيان كانوا إما من خريجي الجامعات الغربية أو الجامعات السائرة على النهج ذاته في الشرق، وبعد أن تكاثروا في المجتمع عمدوا إلى إنشاء الأحزاب القومية أو الشيوعية أو الليبرالية، وجميعها تتفق في الطرح العلماني، وكذلك أقاموا الجمعيات الأدبية والمنظمات الإقليمية أو المهنية، وقد تختلف هذه التجمعات في أي شيء إلا في تبني العلمانية، والسعي لعلمنة الأمة كل من زاوية اهتمامه، والجانب الذي يعمل من خلاله.
ولا يمكن إغفال دور البعثات الدبلوماسية: سواء كانت بعثات للدول الغربية في الشرق، أو للدول الشرقية في الغرب، فقد أصبحت في الأعم الأغلب جسوراً تمر خلالها علمانية الغرب الأقوى إلى الشرق الأضعف، ومن خلال المنح الدراسية وحلقات البحث العلمي والتواصل الاجتماعي والمناسبات والحفلات ومن خلال الضغوط الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي، وليس بسر أن بعض الدول الكبرى أكثر أهمية وسلطة من القصر الرئاسي أو مجلس الوزراء في تلك الدول الضعيفة التابعة.
ولا يخفى على كل لبيب دور وسائل الإعلام المختلفة، مسموعة أو مرئية أو مقروءة، لأن هذه الوسائل كانت من الناحية الشكلية من منتجات الحضارة الغربية –صحافة أو إذاعة أو تلفزة- فاستقبلها الشرق واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتها، وكان الرواد في تسويق هذه الرسائل وتشغيلها والاستفادة منها إما من النصارى أو من العلمانيين من أبناء المسلمين، فكان لها الدول الأكبر في الوصول لجميع طبقات الأمة، ونشر مبادئ وأفكار وقيم العلمانية، وبالذات من خلال الفن، وفي الجانب الاجتماعي بصورة أكبر.
ثم كان هناك التأليف والنشر في فنون شتى من العلوم وبالأخص في الفكر والأدب والذي استعمل أداة لنشر الفكر والممارسة العلمانية.
فقد جاءت العلمانية وافدة في كثير من الأحيان تحت شعارات المدارس الأدبية المختلفة، متدثرة بدعوى رداء التجديد والحداثة، معلنة الإقصاء والإلغاء والنبذ والإبعاد لكل قديم في الشكل والمضمون، وفي الأسلوب والمحتوى، ومثل ذلك في الدراسات الفكرية في علوم الاجتماع والنفس والعلوم الإنسانية المختلفة، حيث قدمت لنا نتائج كبار ملاحدة الغرب وعلمانييه على أنه الحق المطلق، بل العلم الأوحد ولا علم سواه في هذه الفنون، وتجاوز الأمر التأليف والنشر إلى الكثير من الكليات والجامعات والأقسام العلمية التي تنتسب لأمتنا اسماً، ولغيرها حقيقة.
ولا يستطيع أحد جحد دور الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين مستثمرة في الجانب الاقتصادي.
هكذا سرت العلمانية في كيان الأمة، ووصلت إلى جميع طبقاتها قبل أن يصلها الدواء والغذاء والتعليم في كثير من الأحيان، ولو كانت الأمة حين تلقت هذا المنهج العصري تعيش في مرحلة قوة وشموخ وأصالة لوظفت هذه الوسائل توظيفاً آخر يتفق مع رسالتها وقيمها وحضارتها وتاريخها وأصالتها.